الاستعمار الحسّيّ | قصّة

كلمات تقشّر جلدها تحت شمس نيسانيّة مبتدئة، تسهو عن الحَركات الّتي تفرّ بضمّها وفتحها إلى ظلال المعنى، ليبتلعها ظلّي. ألتقطها وأخبّئ فمي بيديّ لأهمسها، إنّها عمليّة بناء ظلّيّ قصيرة الأمد وغير متبادلة على مستوى المنفعة. أو هذا على الأقلّ ما يبوح به الامتعاض الخفيف المرتسم على وجه المرأة الواقفة أمامي. تلحظني بطرف عينها دون أن تستدير حتّى، تسألني بصوت لا يخلو من حقد مدروس:
- أين أمّك يا بنت، ولماذا لا تخرَسين؟
أكرّر سؤالها فتهملني متأفّفة وتُعتقني من مراقبة الأخاديد العميقة المزروعة بعشوائيّة على جانب وجهها. إلّا أنّ عباءتها السوداء تحاصرني مثل شبح مخضرم جاء لمراجعة أدبيّات الموت في القسم المخصّص لتصنيع الفرح، فرحي الّذي دفعت ثمنه بالدولار، صار مرهونًا بمزاج حارس مهلهل يسدّ بعتمته شرفتي الوحيدة الدالة على مرور الزمن: الطابور.
سيسير الطابور دوني وأنا جزء منه، لأجلك يا أمّ الأخاديد سأخرس. عليّ أن أخرس، لأنّ الشمس قبالتي، وكنزتي الصوفيّة الّتي ارتديتها اليوم بتوصية من الطقس الصباحيّ المخادع، تغرس مسامير مدبّبة في جلدي، ولأنّني وقبل كلّ شيء: جئت كي أفرح.
تركب سيّدة الخرس الباص الّذي سيأخذنا إلى الحفرة، وأتبعها بفم ملتو ساخر، سرعان ما اقتبسَته عنّي حين رأتني أشاطرها المقعد، شعرت لحظتها وكأنّني فتاة تسرّبت بسرور قلب من المدرسة الأساسيّة وجاءت لتصبّ طفولتها المقتطعة من عالم مشوّه على العقول الراقية المغلقة بإحكام تحت قماش أسود رخيص.
- الخرس مُعْدٍ.
تقول حركة ثائرة من حركات البناء الظلّيّ الّتي جمعتها قبل دقائق من الآن.
أراقب المقاعد الجالسة على أرضيّة قذرة كي تسمح للجثث القادمة من عوالم لا تقلّ قذارة، بالجلوس عليها. مقاعد بسواعد متآكلة، وأخرى مقضومة، في ما حازت نسبة ضئيلة منها على بقايا ’علكة‘ أكل الدهر عليها وشرب. كان الراديو الصغير الّذي يسرّب صوتًا متقطّعًا لأغان رائجة، موجة السعادة الوحيدة الّتي تهبّ بين الفينة والأخرى محمّلة بمقطع واضح يعلو معه تصفيقنا، أو بالأحرى تصفيقهم.
تقف سيّدة في منتصف الباص وتصرخ:
- صفّقوا.
فعل أمر معطوب لم يفكّر أحد في رتق فجواته الّتي تهزّ الروح مع كلّ ارتدادة بين الصفقة والأخرى، ارتدادات احتجاج مهملة على أنسَنة الفرح. لكنّه فعل مُجْدٍ بما يكفي لترفع سيّدة الخرس يديها وتصفّق بهدوء ورويّة مع انفراجة انتصار صغيرة في فمها توحي بنجاحها في تناسيها لوجودي.
تريد فرحًا صامتًا، يمرّ مثل روح مؤمنة لم تعسّر طريقها إلى القبر. فقد كان الصمت في حضرة الفرح المشترك حلمًا من أحلامها. أتراه سيظلّ كذلك إلى الأبد؟
على هامش الطريق السريع الّذي فقد قيمته اللغويّة لخلوّه من المركبات، توقّفت الحافلة، وبانتهاج سياسة التفتيش الوهميّ نفسها وقفنا في الطابور ننتظر النزول.
- الحفرة أمامنا، فضفاضة، تخترق الأسلاك، لكنّها تمزّق الملابس، كونوا حذرين.
يقدّم رجل أصلع سمين توصية عقيمة لجمهور المنتظرين، ويردف متحدّثًا إلى حقيبته:
- لا داعي للاستعجال.
دفعوه وأسقطوا حقيبته، فدفعت معهم ودست عليها. لكزني على كتفي شاتمًا:
- يلعن أبوكِ.
هنا، على باب الحفرة الفاصلة بين عالمين متقيّحين صرت ابنة لرجل ملعون للمرّة العاشرة، ولأسباب في منتهى الصبيانيّة. لكنّه يستحق أن يُلعَن، وأن تداس الأحرف الجميلة الملتوية لاسمه القصير العفن، الّذي يترك مطلعه انفجارًا حلقيًّا حزينًا لا يليق بصرامة السعادة الّتي يحملها: ’باسم‘. أو ’باسم الملعون‘ بتصرّف من الرجل الأصلع الغاضب وتسعة آخرون دوّنتُ شهادتهم في دفتر مذكّرات رخيص أحمله معي أينما ولّيت وجهي.
قطعنا الثقب الأسود بسلام، دون أن ننتبه إلى التمدّدات والتقلّصات الزمنيّة المستقاة من عالم الأمعاء البشريّة. لم ننظر إلى أصابعنا الطويلة الّتي تقحط الأرض تاركة تعرجات خفيفة في أظافرنا المتّسخة، ولا إلى حقائبنا المتضخمة ووجوهنا المنبهرة بألوان يبدو أنّها عُدِّلت على برنامج ’الفوتوشوب‘ ذات ليلة دون أن ينتبه إليها أحد.
صدمة لونيّة يمكن حتّى لمن أُصيب بتأخّر نمائيّ أن يكتشف فيضانها على الوجوه النازحة بإرادتها إلى الفرَح المدفوع ثمنه سلفًا.
- حتّى الرائحة تختلف.
تقول امرأة عشرينيّة تحمل ابنها في يد وتصوّر في اليد الأخرى بثًّا مباشرًا عبر ’فيسبوك‘ لمدينة حيفا.
- السماء واسعة.
يستفيض زوجها في وصف الحدود المكانيّة بإزالتها، في ما تنظر إليه زوجته بإعجاب مبالغ فيه بالنسبة إلى عمر زواجهما الّذي يمكن تخمينه بالنظر إلى السنوات الخمسة الّتي تسير على الأرض بجانبهما، والسنة الطازجة الأخرى المحمولة بلامبالاة على كتفه. من الواضح أنّها سنة مهملة، جاءت على نحو عرضيّ لم يحارب أيّ منهما لأجله، لكنّها سعيدة رغم كلّ شيء، تنظر حولها بامتنان غير مفهوم وتتفاعل باستخدام أوسع حدّين وصلت معرفتها إليهما: الضحك والبكاء.
وصلنا إلى مركز المدينة، لم نرتجل أيّ طابور، فقد احتجنا إلى وقت معقول لاستيعاب براح الصورة. كنت آخر المتخلّين عن مقعدهم، حتى أنّ سيّدة الخرس تمهّلت قليلًا أثناء نزولها علّني أتبعها وأكفّ عن تحديقي التوحّديّ في الفراغ العقيم الّذي يبدو مستهجنًا بالنسبة إليها، تمامًا مثل تحدّثي إلى نفسي حين كنّا في طريقنا إلى الحافلة.
أتعمّد قهرها بصريًّا، عليها أن تدفع ثمن وقاحتها المغلّفة بوقار من اجتاز الخمسين من عمره بأقلّ الأضرار الجسديّة الممكنة، وفور نزولها أحتضن حقيبتي وأدسّ الحركات اللقيطة في جيبي ثمّ أتبعها.
يسيرون في مجموعات، عائلات، أصدقاء وزملاء عمل. أنا كنت في مجموعة مَنْ لا مجموعة لهم، إلّا أنّني لم أسر معهم وقرّرت الهرب.
شعري القصير المتعرّج مثل أظافرنا العابرة للزمن يدخل في عيني، ينقّي المشهد الملوّث باستراحات تهوّن وحشة المراقبة المريرة لمدينة كلّ ما أعرفه عنها هو اسمها وتاريخها المطبوع في جيبي. أشعر بطعم فرويّ في فمي، أحاسيسي كلّها معلّقة في سماء حيفا الّتي سأذهب لاستكشافها عبر ’التلفريك‘. شعور غريب أن تلمس الخارطة بعينيك.
لا أحد يعرف متى سيطر هذا الصندوق الشفّاف على السماء، لا أعرف كيف وجدتني أصطدم بكلّ أولئك الّذين جاؤوا معي في الحافلة، "المُحرَجون والمُحرِجون طابوريّاً" يصطفّون بسخف بين قضبان حديديّة في انتظار دورهم الخرائطيّ، يتأرجحون، يتراقصون، يشيرون بأيديهم كلّها إلى الأفق المفتوح متغاضّين عن رائحة البراز الّتي تهبّ من مكان غير معروف، ولا يملكون وقتًا لمعرفته.
انتظرت بحماسة لا تقلّ عن حماسة الجميع، حتّى أنّني لم أمانع حين جاء دوري البقاء واقفة داخل الصندوق الغريب إلى جانب سيّدتان فلسطينيّتان وشابّان يهوديّان لم يحافظا على مسافة آمنة بيننا وبينهم، كما أنّنا لم نحاول تعديل هذا التوزيع الجائر للحدود. أخذتنا المشاهِد، منذ البداية ونحن نزحف نحوَ المشاهِد، كنّا في حالة جوع بصريّ لحيفا الّتي لم تعد مجرّد خطّ رفيع على الخارطة.
- لماذا لا تصوّرين؟
تسألني إحدى السيّدتين، فأنظر إليها نظرة مطوّلة من تحت حاجبيّ دون أن أُجيب. تقول لها السيّدة الأخرى متجاهلة وجودي:
- سنذهب إلى البحر فور نزولنا.
لم يكن بحوزتهنّ ملابس بحر، إلّا أنّ معلومة كهذه لن تنغّص عليهنّ، سيُصدَمن فور نزولهنّ، أمّا الآن، فلا يملكن سوى التركيز الهائل على جودة التصوير، كي يرى العالم المتروك خلفهنّ كيف يعِشن.
وصلنا إلى الضفّة الأخرى، وقفنا على أقدامنا وشاهدنا ’التلفريك‘ يلتقط أشخاصًا آخرين ويصعد بهم. لا يعود خاليَ الوفاض أبدًا، وكأنّه ’بقجةٌ طيّارة‘ تحمل المادّة الوحيدة الّتي لا يُمكن محوها على الإطلاق: البشر. تعيد تدوير مشاعرهم خلال الدقائق القليلة الفاصلة بين الضفّتين، تُغريهم، تُنسيهم، تعزّيهم وتحرفهم عن المعنى المختبئ بين طيّات الجمال بتأمينهم على الأرض والسماء.
- التعمية بالإبهار.
تصرخ حركة انفلتت من جيبي واخترقت أذني لتخلق جملة سبق وسمعتها في درس قديم عن الإعلام الجديد، مضحّيّة في ساعاتها الطويلة من البناء الظلّيّ، لتموت بشرف تحت شمس في أقصى حالات إشراقها.
لديّ اكتئاب حادّ في لغتي. خرجت للتوّ من بقجة طيّارة وأشعر بالضياع في حيفا. ثمّة بحر لكنّني لا أرغب في زيارته، لأنّه محجوز مادّيًّا، مستهلك مفاهيميًّا وملوحته ستفتّش على التقرّحات القديمة في روحي.
في جوفي طحالب، قذارة، أشلاء وبقايا ناس. تحت جلدي سياج كان يفترض أن يرتق الثقب الأسود الّذي ابتلعنا، لا أدري كيف ابتلعته. سأجلس على قارعة الطريق وأبكي، إلى جانب شجيرة سرو صغيرة مزروعة داخل قوّار سقيم، تجرح ترابها حفنة من أعقاب السجائر الّتي سرطنت جذعها وصبغته بألوان ترابيّة أكثر من التراب نفسه.
- لستِ أوّل من يتحدّث إلى شجرة السجائر.
تستحوذ سيّدة عجوز على المشهد السورياليّ الّذي لا يتجاوز عرضه الخمسين سنتيمترًا، وتحاول توسيعه بنثر يديها القذرتين على أطراف الشجيرة مردفة:
- ستعيش قزمة إلى الأبد. مع ذلك لن أبيعها بأقلّ من خمسين شيقلًا.
تهزّ رأسها وتبتسم للأفق.
- يداكِ قذرتان.
علّقت محدّقة في الورود المزروعة على فستانها الأزرق، ورود لا تقتلها الأوساخ، ولكنّها تزيد من قتامة ألوانها. حفلة "سرطنة قسريّة مشتركة" تجري على أرض هذه العجوز وأشيائها. نظرت إلى وجهها بإشفاق وناولتها المبلغ المطلوب، دون أن أعقّب.
كان لأظافر قدميها السوداء السميكة هيئة بركانيّة تشبه الألوان الميّتة للصخور الناريّة، أظافر طويلة لم تخجل من تعريتها أمام خلق الله ونباتاته، ومشاهده الطبيعيّة وبقَجه الطيّارة. أظافر ستنظر إلى الأمام حتّى آخر يوم في حياتها، ولن أنظر إليها سوى مرّة واحدة في حياتي، هذه المرّة.
لديّ ارتجاع لغويّ، لا يمكنني ابتلاع كلماتي أو حتّى وضعها في سياق مشاعريّ مناسب. أقتني شجيرة مسرطَنة، يجرحني التعنيف البصريّ الموجّه من أزهار على قماش إلى عيني، وأشعر بالحزن لأجل أظافر سيّدة عجوز قد تموت قبلي. لربّما كانت أمّي على حقّ حين قالت إنّني لا أعرف كيف أعيش.
تلاحقني مرجعيّات الأشياء وظلالها، لأنّ الضوء أصبح التمثيل الوحيد للعيش السريع. لهذا السبب لم أجد أيّ عزاء في ملاحقة الوجوه المحترقة بسعادة تحت أضواء الباص البرتقاليّة فور عودتي. لا يمكن لهذه العجالة الشعوريّة أن تستقطب تمهّلي الظلّيّ، حيث تصاغ الحركات بعناية، وتصدأ وتُنتَهك.
لا أفراح تجمعنا، فلا تنظري إليّ بشماتة يا سيّدة الخرس. وأرجو ألّا تعذرني أيّها الأصلع المهمّش مثل حزن في منتهى البداهة والصغر، لأنّني ابنة عائلة، وإن كنت لا أستخدمها في حياتي، إلّا أنّني سأُكرَه على استخدامها في مماتي الّذي يبدو لي على الدوام ملكًا لكلّ شيء عداي.
- يقولون إنّكِ جئتِ دون عائلتكِ لتقابلي ’حبيب القلب‘ على راحتكِ.
تنبّهني سيّدة الخرس بنظرات معلّقة في السقف المحترق لونيًّا. ويستنكر شابّ كان في طريقه إلى مقعده حين سمعنا:
- وفوق هذا الخزي كلّه، يهديكِ شجيرة ميّتة؟ لا عجبَ في حزنكِ إذن.
أفتّش في جيبي عن الحركات، أمرّر يدي بهدوء بين أغصان الشجيرة، أغمض عيني منادية عتمة الإجابة حيث تختبئ معارفي، فلا أجد شيئًا. أنا ذات أنثويّة عائمة في زمكان ’قيد التصميم‘، يقال إنّه من بين الأشياء ما بعد الحداثيّة الّتي يسعى إليها هو الاستعمار الحسّيّ.
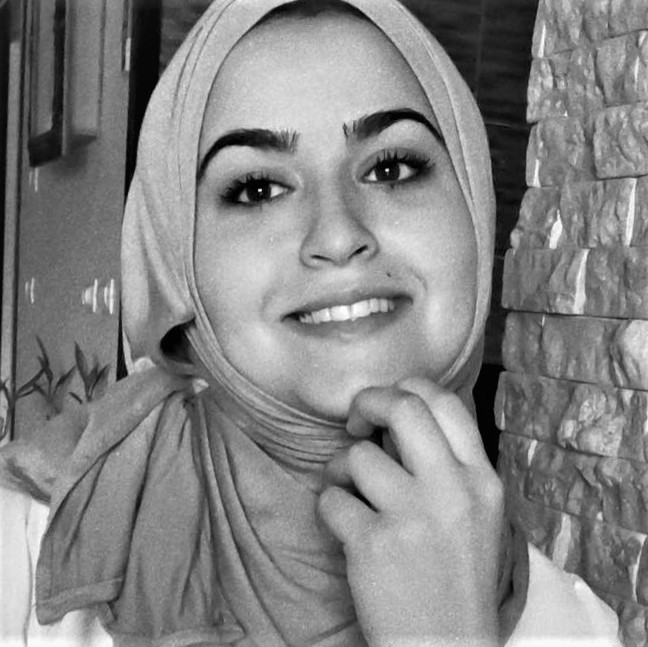
كاتبة فلسطينيّة من مواليد مدينة بيت لحم عام 1999، دَرَسَتْ «الإعلام» في «جامعة بير زيت»، وصدرت لها عدّة روايات، وتكتب في عدد من المنابر الإعلاميّة الفلسطينيّة والعربيّة.





